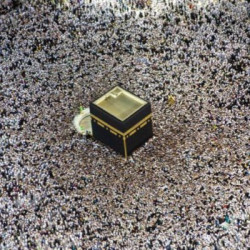د. علي بانافع
📌 بادئ ذي بدء إذا كنت في عجلة من أمرك فأجل قراءة المقال لطفاً لأنه بحاجة إلى تأمل!! 📌
الإسلام في ظهوره كان معبراً عن حاجة مصالح واحتياجات الأُمة العربية، وكان الإجابة الأكثر من ناجحة على التحدي الذي واجه الأُمة العربية، ولعلنا نذكر أن النبي ﷺ قد وُلِد عام الفيل 571م، العام الذي واجهت فيه الأُمة العربية أخطر تحديات عمرها منذ أو وُجدت إلى اليوم، فلأول مرة -ولآخر مرة بإذن الله- يصل جيش معادٍ إلى مشارف مكة المكرمة وبهدف دك أقدس أقداسها وأحرم حُرماتها، وجاء الإنقاذ الرباني العاجل في مناقير طير أبابيل، وجاء الإنقاذ الدائم بمولده ﷺ، الذي لم يُبعد الخطر الحبشيُّ فحسب بل وخطر سادتهم البيزنطيين إلى الأبد من جزيرة العرب، ولا ننسى أن العرب قد نُصروا -أيضاً- في صدامهم مع الفرس في واقعة "ذي قار" ببركة رسول ﷺ، كما في الحديث الطويل: (وبي نُصِروا)، ولو أخذنا بمنطق بعض مثقفي اليوم لما فهمنا معنى أن يُنصر مشركون يعبدون الأصنام ببركة رسول الله ﷺ على مشركين يعبدون النار؟!، فما دخل رسول التوحيد ﷺ بانتصار أو هزيمة العرب المشركين؟! {أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ} [التوبة: 43]. وهل يجوز أن يتساءل مسلم لماذا يزهو الرسول ﷺ بنصر التراب والعصبية الجاهلية؟! حاشا لله وإنما هو الوطن ولا عقيدة ولا رسالة لمن لا يهتم بمصير وطنه، ولماذا لا تحمل الرسالة الخير للوطن أول ما تحمل؟! ومنه ينبثق الخير للناس جميعاً؟!
إن إنكار القومية والزعم بأنها تتنافى مع الإسلام، والسخرية من التعلق بالتراب، دعوة توشك أن تفضي ببعض المثقفين الإسلاميين إلى مأزق شديد الخطورة، نفس المأزق الذي سقط فيه الشيوعيون عالمياً -وبالذات عربياً- في قضية فلسطين، عندما رجحوا انتماءهم العقدي "الأيديولوجي" على انتماءهم الوطني، أو جعلوا المذهب يتقدم على التراب، فخسروا الاثنين -معاً- وخرجوا بتهمة الخيانة التي مازالت تُطاردهم إلى اليوم، القوميات هي الحقيقة الراسخة في تاريخ البشرية، وهي الأساس في انقسام الناس إلى شعوب وقبائل ليتعارفوا، وهي القوة المحركة لما يجري اليوم في العالم من أحداث نقف متفرجين عليها، عاجزين عن الفهم، تتربص بنا القوميات، ونفزع نحن من تعاظم دور القوميات، أما نحن فنتنكر أو ننكر قوميتنا، تارة باسم الأُممية الشيوعية، وتارة بإسم الأُممية الإسلامية.
الإسلام لا يُعادي ولا يُناظر حقائق التاريخ وإنما يرتفع بها، فالإسلام يُقر العربي عربياً والفارسي فارسياً، ولكن لا يرى فضلا لأحدهما على الآخر إلا بالتقوى، فالإسلام هو الفلسفة والروح والرابطة والإطار والخُلق الذي يحقق التعاون وتعايش القوميات في ظل وحدة حضارية تقوم على تعدد القوميات وتمنع تحولها إلى شوفينية أو شعوبية متعادية، الشوفينية هي التي جعلت أُمتين عظيمتين صنعتا -معاً- واحدة من أجمل صفحات التاريخ، تجعلهما تتنازعان على اسم "خليج البصرة" أما الإسلام فهو الذي لم يُثر هذا الأمر لأكثر من ألف سنة بل جعل العرب يسمونه الخليج الفارسي لأنه يفضي إلى بلاد فارس والعكس من الجانب الآخر الخليج العربي لأنه يفضي إلى جزيرة العرب، والإسلام اليوم هو الذي يُمكنهما من حل هذا المُشكل بتسميته الخليج الإسلامي -ولكنهما لا يفعلان- أسوة ببحر الروم الذي تحول إلى بحر المسلمين واليوم تحول إلى البحر المتوسط بفعل القوميات.
القوميات لابد لها من عقيدة "أيديولوجية" أو صيغة حضارية تُعبر بها عن نفسها؛ وكل قومية تلعب أو تطمح أن تلعب دوراً إقليمياً أو عالمياً لابد لها من رسالة عقدية، تُعبر عن ذاتها وتُخاطب بها الآخرين في نفس الوقت، وهذه العقيدة أو الأيديولوجية قد تبدأ من قومية بعينها، وتكون في فترة من الفترات مُعبرة عن مصالح هذه القومية ورسالتها الحضارية للعالم، والذي يحدث عادة هو تَجْمَع عدة قوميات في إطار حضاري واحد يقوم على هذه العقيدة أو الرسالة، وهذه الرسالة تتباين في الوسائل والأهداف والنتائج المتحققة، فهناك -مثلاً- الأيديولوجية الإمبراطورية حيث يجري قمع القوميات الأخرى لحساب القومية صاحبة الرسالة، كما حدث في الحضارة أو الامبراطورية اليونانية والرومانية والفارسية وروسيا الأرثوذكسية ثم روسيا الشيوعية الماركسية، والامبراطوريات الغربية الأوروبية والأمريكية منها، التي قامت على النصرانية الغربية ورسالة الرجل الأبيض، أما في حالة الإسلام فقد قام متحد من نوع خاص لم ينف القوميات ولا استنكرها كما يتصور المُشتبه عليهم، وإنما اعترف بها ووفر لها كلها أقصى درجات المساواة المُمكنة، وخفف حدة تصادمها وأثرى تفاعلها وأحل الفكر في تنافسها محل السلاح، فظهر التراشق بالشعر والنثر والتفاخر بهما، كما حدث في مرحلة إزدهار الحضارة الإسلامية بين العرب والفرس، فيما سُمي في الأدب الإسلامي بالشعوبية أو التنافس في التفوق العلمي والفقهي واللغوي حتى يضع أعجمي قواعد اللغة العربية ويصبح أهم مرجع لحديث النبي العربي ﷺ.
الإسلام كان أفضل العقائد والأيديولوجيات في تحقيق الرسالات العالمية، بما كفله من مساواة بين قومياته المتعددة، وما وفره لكل قومية من فرص بعث وتنمية وتطوير ثقافتها الخاصة، ولما تحقق في ظله من تفاعل وإخصاب بين هذه القوميات والثقافات في ثقافة إسلامية واحدة، حتى إنه يمكن القول بأن جميع هذه القوميات بلا استثناء قد مثلت في السلطة ووصلت على نحو أو آخر إلى أعلى مراتب هذه السلطة، وحتى إن سائر القوميات التي فتح العرب بلادها ودانت بالإسلام احتلت حجماً في الحضارة الإسلامية يصارع إن لم يتفوق على حجم العرب!!، ولا يجوز أن ينطلي علينا مكر الشعوبية الجديدة التي تُهاجم حكم بني أُمية بزعم أنه كان يمثل سيطرة العرب ويتنافى مع المساواة التي جاء بها الإسلام، تلك المساواة التي لم تتحق أو ترجع -على حد زعمهم- إلا بسيوف من كانوا يتنادون بذبح كل عربي جاوز الشبر!!
إن لعن جنس العرب في بني أُمية بالذات أصبح مطية لكل ذوي الأهواء والأغراض، فالدولة الأُموية هي أبرز صفحات حضارتنا العربية الإسلامية، وهي التي نشرت الإسلام في ثلاث قارات وإن لم تكن دولتهم بالتأكيد في طهارة ونبل حكم أو عصر الراشدين، ولكن تلك قضية بعيدة كل البعد عن تخرصات الشعوبيين الجدد، وعن اتهاماتهم لبني أُمية بأنهم كانوا يعتمدون على العنصر العربي في حكم الدولة الإسلامية الواسعة الأرجاء المترامية الأطراف، والتي لم تتوحد إلا في ظل بني أُمية، ما اعجبه من افتراء وليس اتهام!!، لقد حكم بنو أُمية مائة عام هي سنوات الفتح والاخضاع والتطويع، فعلى من كانوا سيعتمدون في إقامة الدولة وفرض النظام الجديد، على الطبقة المخلوعة التي كانت في السلطة بالأمس أم على العرب الفاتحين والحاملين لراية ورسالة الإسلام؟!، هذه الطبقات المخلوعة حتى وإن قلنا إنها تخلت عن أحقادها وأطماعها في استرداد ملكها، حتى لو قبلنا أن هذه الأجيال الحديثة العهد بالفتح والهزيمة والإذلال، قد شرحت قلبها للإسلام وأخلصت له -ربما- ولكنها لم تكن قد تشربت بعد روح مبادئه، وهي لو حكمت فإنها ستعيد سيرتها الأولى أساليب الأكاسرة والدهاقنة ولكن باسم الإسلام، الأمر الذي سيدفع رعاياها لا للثورة على الحكومة وحدها بل وعلى الإسلام بأسره!!
كان الحكم العربي الأُموي ضرورة من كل النواحي لاستقرار حضارة الإسلام وترسيخ قيمها وتألق هذه القيم، وما ظهر في ظل الحكم الأُموي من كفاءات ورجالات ورئاسات من غير العرب هو أصدق دليل على تهافت الافتراء والاتهام للأُمويين بالشوفينية أو اضطهاد غير العرب، وتذكروا من فتح أوروبا؟! ثم حقيقة أن الموالي لعبوا الدور الأول في إسقاط الحكم الأُموي، كلها شاهد على أن غير العرب ما كانوا مضطهدين ولا مقهورين ولا ممنوعين من التطور والمشاركة في حدود الضرورات لدولة في مرحلة الفتح والاستقرار، أتمنى على ذوي الأهواء أن يراجعوا أنفسهم ألف مرة قبل الانسياق على الحملة المُغرضة على الأُمويين، وليسألوا أنفسهم: هل الحكم الذي قام بعدهم كان أفضل من حكمهم؟! ألا يعني هذا السب للأمويين نفي التاريخ الإسلامي كله إلا فترة حكم الراشدين؟! هل تخلى عن مبدأ الوراثة في دولة العباسيين أو ما قام من دول الشيعة وشتى دول الإسلام؟!
الذي أدخلنا التاريخ محمد ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم ندخله بأبي جهل وأبي لهب وأبي معيط، ولم نفتح الفتوح بالبسوس وداحس والغبراء، ولكن فتحناها ببدر والقادسية واليرموك وحطين وعين جالوت، ولم نحكم الدنيا بالمعلقات السبع أو العشر، ولكن حكمناها بالكتاب والسنة، ولم نحمل إلى الناس رسالات اللات والعزى ومناة، ولكن حملنا إليهم رسالة الواحد القهار ..