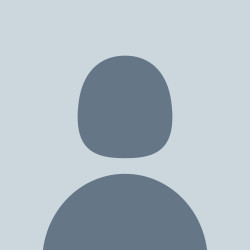كتاب "فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" - دراسة وتقديم: مدحت صفوت.
تُعتبَر قضيّة التوفيق بين الدين والفلسفة من أهم القضايا التي شغلت بال الفلاسفة المسلمين قديمًا، من الكِندي أولًا، مرورًا بالفارابي وإخوان الصفا ثانيًا، وصولًا لابن طُفيل ثالثًا، وانتهاءً بابن رُشد رابعًا، وبدأت هذه الإشكاليَّة تَطرح نفسها بجلاءٍ مع وُفود الفلسفة اليونانيَّة إلى الفضاء العربي والديار الإسلاميَّة، إبَّان حركة الترجمة العظيمة التي قام بها العبَّاسيون وبلغت ذروتها في عهد الخليفة المأمون (المتوفَّي سنة 218هـ)، بعد أن وجَّه اهتمامه إليها الفيلسوف العربي والإسلامي الأول يعقوب بن إسحاق الكِندي (المتوفَّى سنة 256هـ). حيثُ انقسم المُفكِّرون الإسلاميُّون وجمهور العُلماء وقتذاك إلى فريقين، فريقٌ يرى بأن الفلسفة هي ابتعادًا صريحًا عن الحق الإلهي الذي أنزله الله عن طريق الوحي في صورة شرائعٍ وتعاليم، فضلًا عن أنها شيءٌ دخيلٌ وغريبٌ على المُجتمع الإسلامي، ومُخالِفٌ لروح الدين وأصوله ومبادئهُ، أي أنهم قالوا بتقديم النقل - النص الديني - على العقل. وفريقٌ آخر يرى بأن الفلسفة ما هي إلَّا تمكين الإنسان لأن يصل إلى الحقائق الكليَّة والإلهيَّة المُجرَّدة، ليس عن طريق النصوص والشرائع الدينيَّة فحسب، بل وأيضًا عن طريق النظر العقلي الخالص والتأمُّل والعلم الإنساني المحض، أي أنهم قالوا بالعقل لا بالنقل وحده، وكان ابن رُشد من الفريق الثاني الذي ارتأى ضرورة التوفيق بين الحكمة والشريعة، فألَّف لنا هذا الكتاب.
وقد تبدو الفكرة التي اعتمدها ابن رُشد واتَّخذها غايةً في هذا الكتاب هي في ظاهرها فِكرةً جيِّدة، أو هي حلَّاً يُرضي الطرفين، الطرف الديني والطرف الفلسفي، ونستطيع أن نأخذ انطباعًا مبدَئيًا مِن عنوان الكتاب فقط بأن هذا المنطق الرُشديّ يرمي في محاولته للتوفيق والمُصالحة إلى آفاقٍ أوسع في الفِكر العربي، ويقودنا إلى طريق الحضارة والحداثة والتقدُّم، مِمَّا يجعل البعض يُعجب بهذه الفِكرة ويجدونها أكثر عقلانيَّةً من أن يرفضوا الفلسفة من الأساس في مقابل تمسُّكهم بالدين، وقد ينجم عن ذلك استمساك المُفكِّرين العرب بابن رُشد، ومحاولة التقرُّب به إلى العقلانيَّة اللامتناهيَّة في صدقها، باعتباره حلقة الوصل بين الشرق الإسلامي والغرب، لذلك فلا عَجَب اليوم من أن نرى بعض التنويريين الذين يتوسَّلون بإبن رُشد وفلسفته، ويرون أننا لن تقوم لنا قائمة إلَّا بها، وكأنَّها خلاصنا الوحيد أمام تخلُّفنا الفِكري. والأمر تجاوَزَ ذلك وأصبح ضرورة لنلحق بالركب الحضاري، عملًا بالمبدأ القائل بأنه «ليس في الإمكان أبدع مما كان»، وبأنه «لا يصلح أمر هذه الأمة إلّا بما صَلَح أولها».
ومثالًا على هؤلاء المتمسّكين بآرائهم حول ابن رُشد نذكُر المُفكِّر عاطف العراقي، والمُفكِّر مراد وهبة، في دعوته لضرورة إحياء فلسفة ابن رُشد، بوصفها "أداةّ لجِسر الهُوُّةِ بين الغرب والمُجتمع الإسلامي"، كَما أن هذه الطريقة في التوسُّل بالقديم تلتجئ إليها الأصوليات كما نعرف، سواء كانت هذه الأصوليات دينيّة أم فكريّة، ذلك أن الأصوليّة لا تقتصر على الدينيين فحسب، وإنما تمتد لتشمل ما يدّعون التنوير وما يُسمُّون بالتنويريون؛ لأن الأصوليّة في حد ذاتها هي موقِف الذين يرفضون تكييف عقيدةٍ أو ايديولوجيّةٍ أو فِكرةٍ مع الظروف الجديدة والمُعاصِرة لهم، وهذا على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي، وهي نَسَقٌ يستند على الجمود والتصلُّب ومُعارَضة التطور، والتشدُّد في الانتساب للتراث ومُنتَج السلف.
وعلى الجانب الآخر من هذا الاتجاه الأصولي، في سبيل تكييف الفكرة مع الظروف المُستجِدَّة والمُستجَدَّة، ظهرت محاولات عِدَّة في تحوير الموروث وتطويعه كي يُناسِب لغة العصر، وإعطاءِه طابع المُعاصَرة والاستحداث، وكان الامتطاء الايديولوجي هو المتحدِّث الرسمي باسم هذه المحاولات، إذ حدث أن تقوَّل بعض المفكرين العرب المُحدَثين على فلاسفتهم القدامى، ونسبوا إليهم ما لم ينطقوا به، وانتهكوا حَرَم السياق التاريخي والبيئي لكل فترةٍ زمنيَّة لفلاسفتنا، وسربلوا فلسفتهم في ثوبٍ ايديولوجيّ أو قالبٌ فِكريّ، أو نسَقٌ فلسفيّ مُستحدَث لا يخرجون عنه، أي بالأحرى جاء تصنيف الأقدمون على يدَّ اللاحقون وفقًا للمفاهيم والدلالات الفلسفيَّة المُعاصِرة، الأمر الذي لم يخلٌ من اسقاطات ايديولوجيَّة على الموروث، في تجاهلٍ تام للسياق التاريخي لهذا الموروث؛ فصار أبو ذر الغفاري شيوعيًا ماركسيًا بالمعنى المُستحدث، وأصبح ابن خلدون مُفسِّرًا ماديًا للتاريخ، وصارت فرقة المُعتزلة عقلانيَّةً تقدميّةً تُدافع عن العدالة الاجتماعيَّة!، وانسحب الأمر كذلك على ابن رُشد وميراثه الفِكري؛ إذ حاول المُفكِّر المغربي محمد عابد الجابري أن يُمرِّر بعض التصوُّرات والمفاهيم الحديثة على لسان ابن رُشد لمحاولة إدماج التراث والمعاصَرة جنبًا إلى جنب، الأمر الذي قد ينتُج عنه الامتطاء الايديولوجيّ كما قُلنا أو "التلفيق" بعبارةٍ أخرى.
ولكن الطريقة التي يجب أن نتناول بها أي شيءٍ قادمٌ إلينا من تراثنا، دينيًا أو فلسفيًا، فِكريًا أو ثقافيًا، ليست الطريقة الدوجماطيقيَّة في التنظير، وليست الامتطائيَّة والاسقاطيَّة أو التلفيقيَّة التي تُحابي لغة العصر وتمسخ القديم بإسقاط هذا على ذاك، وتُسقِط عن التراث سِمَته التاريخيَّة، وإنما بالمنهج المُقابِل للتراث بكل وسائل النقد الموضوعي والتدقيق النظري الجاد، في تحليل النص الفلسفي وتفكيكه وردَّه إلى مكوناته الأصليَّة، دون تجاهُل السياق التاريخي، الذي نبتت فيه الفكرة وترعرعت وتأصَّلت. هذه بالنسبة لي خيرُ طريقةٍ ومنهجٍ في تعاملنا مع التراث، إذ لا يكفي أن نمرِّره ونقدمه بطريقة اعتباطيّة هكذا على أنه روشتَّة تنويريَّة - بتعبير صاحب الدراسة - ستنقلنا إلى العالم الأول بمجرَّد اتِّباعها.
صحيح أن الأمم لا ترتقى في المجال الحضاري بغير تراثها، وأن تراث الأُمَّة يُعتبر بمثابة هويَّتها التاريخيّة، ولكن هذا التراث أيضًا سواء كان فكريًا أو دينيًا أو غيره لا يجب أن يُشكِّل عائقًا في التخطيط للمستقبل، ولا يجب أن يستحوِذ على كل شيء ويكون معيارنا ومرجعنا الوحيد في مسيرتنا، في نفس الوقت الذي لا يصحّ لنا أن نمسخه ونلفِّقه كي نضحك على أنفسنا بأننا صرنا تنويريون، فلندع ما للتراث للتراث وما للمعاصرة للمعاصرة، ولا يصطدم هذا مع ذاك، بل يُكمِل كُلٌ مِنهما الآخر، لأن بهذه الطريقة الرجعيّة التي نعتمدها ونقف فيها أمام التراث جامديّ النظر ومكتوفيّ الأيدي ومسلوبيّ الإرادة الجادّة، وهذا المنطق في قياس الجديد على القديم تكون الخيبة الحضاريّة وصلت لأعلى مراحلها، وأظن أن هذا شيء بديهيّ وكلنا نعرفه بل ونعيشه.
« العودة إلى الماضي للحصول على صَكّ المشروعيّة، هي الخطوة المُربِكة التي يلجأ إليها التنويريون العرب، في مسار السير نحو الأمام تتراجع الرؤى التنويريّة خطوةً للوراء، تبحث عن أب شرعي للخطاب الوافِد، عن جذر يُمكِن من خلاله تمرير المُنتج الجديد، قناع يمرر من خلاله التنويري خطابه "الغريب" عن السياق السائد، استحضار صوت ماضوي يحمل عبء تحقيق النهضة المرجوة. خطوة نُعرِّفها بـ"إرادة العودة"، وهي إجراء ارتدادي، يعود بالذات إلى الوراء، وعبرها لا يكتسب الإجراء الفكري الحديث معنى أو مصداقيّة إلا بقدر ما يكون متطابقًا مع الماضي وخطاباته. وهو إجراء استقوائي أيضًا أمام أفكار الآخر المتفوق في كثير من المجالات، عبر استدعاء الأسلاف وخطاباتهم، باعتبارهم الموتى الأحياء فينا.» -مدحت صفوت.
تناول مدحت صفوت - صاحب الدراسة في بداية الكتاب - الخطاب الرُشدي بعد أن عرَض اتجاهين وطريقتين في النقد الموضوعي، الأولى هي الآليَّة النقديَّة المعروفة عند مارتن هايدغر بإسم الهدم Demolition، الهدم الذي يتَّجه نحو كل رؤية قديمة ثابتة يهدمهما ويقوِّضها، بحيث يكون هذا الهدم لهذه الرؤية هو لحظةً في بناءٍ جديد، يهدف إلى رؤية أكثر ثباتًا وفهمًا من الرؤية السابقة عليها، أي ببساطة الهدم بقصد البناء. والمنهج الثاني هو منهج الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا في القراءة التفكيكيَّة اللانهائيَّة Deconstruction للموروث - النص - لمعرفة العلاقة بين النص والمعنى، لأن أبسط النصوص وأكثرها بداهةً عند دريدا تتضمن ما يسميه هو بـ " المُعضلة Aporia " أو التناقض أو الثغرة باليونانيَّة، والقراءة التفكيكيَّة هي إحدى طرق قراءة النصوص والتي تبحث عن هذه التناقضات والثغرات فيما بين السطور، أي أن النظرية التفكيكيَّة بأبسط تعريفٍ لها هي نظريَّة لقراءة النصوص ولتقديم المفارقات والثغرات والتناقضات الخفيَّة في النص إلى العلن أو ما يسمَّى بالمصطلح الدَّارج (قراءة ما بين السطور)، لتوسيع الفهم تجاه هذه النصوص، وهذا هو المنهج الذي تقوم عليه الدراسة التي قدّمها مدحت صفوت في كتاب "فصل المقال" الصادر عن سلسلة التراث الحضاري بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي دراسة ممتازة بالمناسبة، ومتوفِّرة على شبكة الانترنت، أنصح بقراءتها.
ابن رُشد في السياق العربي والإسلامي (الوجه الآخر)
شهيد الفلسفة، كلمتان تجريان على ألسنة البعض من الجامعيين والدارسين للفلسفة، ربما عن تسرُّعٍ في بناء الأحكام أو عدم الدراية الكافية بالموضوع، أو ربما لتخلِّي بعضهم عن أهم خاصية من خصائص الفلسفة، ألا وهي النقد الدائم والمستمِر، لكِن الفلسفة يا أعزَّائي ليست حكرًا على فئةٍ مُعيَّنة أو أفرادًا بعينهم كي لا ننتقدهم، ولربما نحنُ هُنا نُجازِف في انتقاد رجلًا عملاقًا وشارحًا ومترجمًا جليلًا مثل ابن رُشد، رجلًا بفضله اهتدت الحضارة الأوروبيَّة إلى تراثها وأعادت إحياءه عن طريق مؤلفاته وكُتبه وترجماته للتراث اليوناني، وحظى باهتمامٍ كبير ومكانةٍ عاليَّةٍ عندهم، بل أنه دخل في سياق عصر النهضة الأوروبي Renaissance، وأمتنَّت الحضارة الأوروبيَّة له وتيمَّنت به، حتّى ظهر في اللوحة الشهيرة المعروفة بإسم "مدرسة أثينا Scuola di Atene" للرسام الإيطالي المشهور رافائييل إجلالًا له وتقديرًا لما بذله من جُهد، وورد اسمه في كوميديا دانتي الإلهيَّة مع باقي الفلاسفة العظام، ولكن نحنُ هنا نتكلم عن فلسفة ابن رُشد الخاصَّة من خلال كُتبه ومؤلفاته الشخصيَّة، أي نتاجه الفِكري الخاص باعتباره رجلًا فقيهًا مالكيِّ المذهب، لا عن الصنيع الطيب الذي أسداه للحضارة الأوروبيَّة، نتكلَّم عن الفيلسوف الذي عرفته من خلال منهجي الدراسي في الصف الثاني الثانوي بأنه القائل بعدم تعارض الفلسفة مع الدين، العقل مع النقل، والذي بعد قراءتي كتابه هذا تغيَّرت نظرتي له كليًا، وعرِفت أن محاولة التوفيق هذه باءت بالفشل، وقُدِّر لها الإخفاق من قبل أن تخطي حتَّى خطواتها الأولى. وليكن في ذهننا دومًا أن لا صوت يعلو فوق صوت العقل وتحكيمه والاهتداء به والشكّ بواسطته.
في محاولته للتوفيق بين الفلسفة والدين، أعلى ابن رُشد من شأن الدين، وقلَّص من دور الفلسفة، وحَصَرها في نطاق ديني ضيِّق، لتصبح في الأخير لها دور ثانوي واحد، هو استخدامها في برهنة التأويلات القرآنيَّة والنظر في المفاهيم الدينيَّة فقط بما لا يُعارض النصَّ، وبما أن ابن رُشد حَصَرَ الفلسفة؛ فبالتالي العقل مُسخّر كذلك لهذه الخدمة بالتبعيّة، ويقتضي ذلك بالضرورة القضاء على كل ما هو عقليّ، ذلك لأن ابن رُشد لم يُعطِ العقل المساحة والحريّة الكافية التي تلائمه، فأصبح العقل عنده مفهومًا ناقصًا أو لا يُعتدّ به.
ويُقسِّم ابن رشد على حسب قوله مراتِب المعرفة أو مراتِب التصديق للحق على ثلاثة أوجه هي: البرهانيّة، الجدليّة، الخطابيّة، ويُعتبَر جوهر هذا التقسيم قائمًا بالأساس على تصوُّرات أرسطو حول طرائق التدليل، فما كان من ابن رُشد إلا أن استعار وجهة النظر الأرسطيّة هذي ليُكسِبها سِمةً شرعيّة، ويربطها بعلوم الدين والقرآن، ثم بعد ذلك يُفصِّل ابن رُشد الناس إلى ثلاثة مراتِب أيضًا كُلٌ حسب طريقة تصديقه للحق: فنجد البرهانيّون والجدليّون والخطابيّون؛ فالذي يُصدِّق بالبُرهان يُعتبر من أهل البُرهان أي أهل الفلسفة، وينسحب هذا الكلام على الجدليّون والخطابيّون أيضًا، ويَعتبِر ابن رشد أن أهل البُرهان هُم وحدهم من لهم الحق في التأويل ولا يختص بهذا إلَّا هُم فقط، أي أنه قال باقتصار الفهم والعقل والتفلسُف والتأويل على فئة واحدة فقط من الناس!
"فَإِذًا، النَّاسُ في الشَّرِيعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أصنَافٍ: صِنفٍ، لَيسَ هُوَ مِن أَهل التَّأوِيل أَصلاً، وهُم الخَطَابِيُّون، الَّذِينَ هُم الجُمهُورُ الغَالِبُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيس يُوجَدُ أَحَدٌ سَلِيمُ العَقلِ يَعرَى مِن هَذَا النَّوعِ مِنَ التَّصدِيِق. وَصِنفٍ هُوَ مِن أهل التَّأوِيلِ الجَدَلِيِّ، وَهَؤُلاءِ هُم الجَدَلِيُّونَ، بالطَّبعِ فَقَط، أَو بِالطَّبعِ وَالعَادَةِ. وَصِنفٍ هُوَ مِن أَهل التَّأوِيلِ اليَقِينيِّ، وَهَؤُلاَءِ هُم البُرهَانِيُّون بِالطَّبع وَالصِّنَاعَةِ، أَعنِي صِنَاعَةَ الحِكمَةِ."
ليس هذا وحسب، بل إن ابن رُشد يُغالي في الإعلاء من شأن البرهانيون على حساب البقية من الناس، حيثُ نراه يقرَّ بأنه إذا اختصًَ بالتأويل - الذي هو غاية الفلسفة عند ابن رُشد - واحدٌ من الجدليين أو الخطابيين فإنه من وجهة نظر ابن رُشد إمّا آثم أو كافِر!، وإذا توصّل البرهانيّون مثلًا إلى تأويلًا خاصًا فيجب كتمَهُ على العامّة وعدم التصريح به! ومتى صُرِّح بشيءٍ مِن هذه التأويلات لمن هو من غير أهلها وبخاصةً التأويلات البرهانيّة، أفضى ذلك بالمُصرَّح له والمُصرِّح إلى الكُفر!. وهُنا نجد تقاربًا شديدًا بين هذا المنطق والمنطق الذي كان يستخدمه الغزالي؛ فالغزالي صاحب مفهوم "المضنون به على غير أهله" ويكثُر استشهاده بأحاديث من مثل «لا تعلِّقوا الدّر في أعناق الخنازير» شارحًا المثَل بأنه إفشاء المعرفة لغير أهلها، والكثير من هذه المصطلحات الكهنوتيَّة التي تفرِض الوِصاية على عقول الناس!
"فالتأويلاَتُ لَيسَ يَنبَغِي أن يُصَرَّحَ بِها لِلجمهُورِ، وَلاَ أَن تُثبَتَ فِي الكُتُبِ الخَطَابيَّةِ أو الجَدَليَّةِ، أعنِي الكُتُبَ الَّتِي الأقَاويلُ المَوضُوعَةُ فِيهَا مِن هَذَينِ الجِنسَينِ، كَمَا صَنَع ذَلِكَ أبو حَامِد."
"وأَمَّا المُصَرِّحُ بِهَذه التَّأوِيلاَتِ لِغَيرِ أَهلِها فَكَافِرٌ، لمَكَانِ دُعَائِهِ للنَّاسِ إِلَى الكُفرِ"
الكهنوت بين الإنكار النظري والإقرار الفِعلي
إذا ما نظرنا إلى فلسفة ابن رُشد بتمعُّنٍ، فإننا نجدها تقوم ضمنًا وفي طبيعتها على المبدأ التراتُبي Hierarchy Principle في الدين والفِكر، أشبه كثيرًا بمبدأ الكهنوت في المسيحيَّة إن أردنا تقريب الصورة، ولربما يخلو الإسلام من مبدأ الكهنوت من الناحية النظريَّة أو ما تقِرَّه الشريعة الإسلاميَّة، لكن الممارسة الفعليّة في أغلب تاريخ الفِكر الإسلامي تُخبِرنا بعكس ذلك، إذ إن هذه الطريقة بالضبط هي التي وضعت العُلماء في مرتبةٍ عاليّةٍ ومكانةٍ مُقدَّسةٍ، إلى أن وصل الأمر حد رَفض النَقد أو المُساءَلة، كما في حال أصحاب علم الحديث، وخاصةً الإمام البُخاري (الجليل).
وأود هُنا لو سمح لي القارئ بأن استَطرِد وأوضِّح شيئًا بخصوص البُخاري وصحيحه، هو أن الإمام البُخاري في كتابه المُعنوَن بـ (صحيح البُخاري) كانت غايته هي تنقية الأحاديث من الاختلاق والكذب والتلفيق، الذي كان شائعًا في عصره، ومعرفة الصحيح ورد المُشتبِه، بوسائلٍ قاصِرةٍ في التحقُّق والنقد، وبطريقةٍ ومنهجٍ خاصّ به؛ حيثُ انتهج البُخاري نهجًا هو ما نسميه اليوم بـ " نقد السند "، أو ضبط سند الحديث من خلال سلسلة الرواة، والبحث عن أحوال وصفات رجال الحديث. وينبغى هُنا أن نُفرِّق بين السند والمَتن، بين سِلسلة الرواة، ومَضْمون الحديث، لأن هذا المضمون لم يتعرَّض له البُخاري بأي شكلٍ من الأشكال، هو فقط قام بضبط هذه السلسلة، واستوفى الحديث وفقًا لصحة هذه السلسلة، إن صحَّت. أمَّا ما يُعرف بـ " نقد المَتن " فهو علمٌ آخر تمامًا، ومن القواعد التي قَرَّرها أهل الحديث أنه لا تلازُم بين صحة السند وصحة المتن، فقد يصح السند ولا يصح المتن، لمخالفة المتن لأصل شرعي ثابت أو للعقل أو للواقع أو للتجربة! ومن المُفترض أن يكون نقد المتن سابقًا على نقد السند، ومِن المُفترض أيضًا أن تكون القاعدة عند علماء الحديث هي كما لخَّصها الإمام الحافظ ابن الجوزي (المتوفَّى سنة 597هـ) - رحمه الله - في قوله: « مَا أحسَنْ قَول القَائلِ: إِذَا رَأَيْتَ الْحَدِيثَ يُبَايِنُ الْمَعْقُولَ أَوْ يُخَالِفُ الْمَنْقُولَ أَوْ يُنَاقِضُ الْأُصُولَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ»، ولكن جرت العادة وأصبح المُتَّبع - للأسف - هو القبول بصحة السند فقط، وإن كان المتن يُخالِف أصلًا مِن أصول الدين، أو يُخالِف المصدر الأول للتشريع (القرآن)، أو يُناقِض العقل، أو الواقع، أو التجربة كما ذكرنا، الأمر الذي جعل دار الإفتاء المصريَّة تأتي بعد مرور أكثر من ألف عام وتقول بأن « المُشكِّك في صحيح البُخاري فاسِق مردود الشهادة.»
«وأما الأخبارُ التى بأيدينا الآن، فإنما نتَّبعُ فيها غالب الظنِّ، لا العلم المحقَّق» — ابن النفيس.
إذًا، مُشكِلتنا في قضيَّة البُخاري ليست معه في الحقيقة، ولكنها مع أنفسنا، نحنُ الذين توقفنا عنده، دون أن نتخطَّاه خطوة واحدة، وأغلقنا باب المناقشة والتحقيق، وأبقيناه موصدًا أمام كل تساؤلٍ وسؤالٍ، وأعطينا للأحاديث المُنتقاة بواسطته قداسةً لا يضاهيها قداسة وتعظيم الهنود للبقر، دون أن نستعمل نحنُ وسائل النقد وآليات التحقُّق الحديثة، في التساؤل عمَّا إذا كانت هذه الأحاديث تَتَّفق مع العقل ومع المفهوم العام والاصطلاحي للإسلام أم لا تتفق؟ وبالتالي فإن الخطأ يرجع للجمهور وانسياقه الأعمى وراء كل اجتهاد، وميله الفطري لتبجيل القدماء والاحتفاء بهم، لا على البُخاري الذي انتقَد وحلَّل ونقَّى وكَشَفَ، ويعود على الناس في تقديسهم الأئمة والعُلماء المُسلمين واجتهاداتهم، لا على الأئمة أنفسهم الذين اجتهدوا وانتقدوا، سواء كانوا قد أصابوا أو أخطأوا، ومثل هذا التقديس وهذه الفلسفة التي أقرَّها ابن رُشد يتشكِّل لدينا دوجما Dogma في تعامُلنا مع التراث، إن لم تكن قد تشكَّلت بالفعل.
والأمر لا يقتصر على تعاملنا مع التراث وحسب، بل إن الأمر يتجلَّى في مُمارسات سلطات الشعوب العربيَّة، السياسيَّة أو الدينيَّة، وفي التعاملات الاجتماعيَّة فيما بين الأشخاص، على نحوٍ بَشِع، إذ لا يختص بشأن الأمور الدينيَّة إلَّا سُلطة واحدة في المجتمع، أفرادها هُم حاملي الأسرار، ووارثي العقيدة، وخُلفاء الله في الأرض، والأنكى من ذلك أنهم مُكتَسِبين هذه المكانة أو الرتبة الاجتماعيَّة Social Status من أفراد المُجتمع نفسه ومُعظم المتدينين فيه؛ فكما يحصل الفقهاء والعلماء من تاريخنا على مكانةٍ مُقدَّسة عندهم، يحصل رجل الدين أيضًا على مثل هذا الشأن في المُجتمع بين الناس، ومثل هذه المكانة العاليَّة التي يُعطيها الأفراد لرجال الدين في كل مُجتمع، هي فعل اجتماعي نسبي، يختلف من مُجتمعٍ لآخر، ومن فردٍ لآخر، ولا نُبالِغ إن قُلنا بأنها أصل كل الشرور، من جهلٍ وتجهيلٍ وطيشٍ وحماقةٍ.
وقد تجِد هذه السُلطة الدينيَّة سندًا فلسفيًا عند ابن رُشد، تُبرِّئ به نفسها من جميع السلوكيات وكل الضعط التي تُمارِسه على العقل الجمعي، وتُعطي لنفسها الحق في توجيه عقل الأُمَّة أينما شاءت، والحق في الوصاية على عقول الأفراد ومُحاسبتهم إن أخطأوا، وتستحيل كل سلوكياتهم من أسبابٍ للتجهيل والظلاميَّة إلى تبعياتٍ ونتائجٍ مُسنَدة إلى هذه الفلسفة (التنويريَّة!)، بما تتضمنه من هيراركيَّة صريحة وكهنوتٍ واضح.
وحسبُنا أن ننظر إلى الممارسات التي ترتكبها هذه السُلطة في حق كل شخص يُفكِّر، أو يحاول أن يأتي بجديد، حيثُ ما أن يختصُّ هذا الشخص بالتفكير والنقد في مسألةٍ مُعَيَّنة، حتَّى يظهر الباطن الكهنوتي للخطاب الأصولي الإسلامي، في صورة شبه احتكاريَّة للحق المُطلق، وبطريقة ردعيَّة وتضييقيَّة على العقل، وينقلب الوضع رأسًا على عقب فوق رأس كل مُفكِّر حقيقي ومُثقف حُر، وربما لا نجد مُجتمعًا من المجتمعات الدينيَّة إلَّا ونرى تواطؤًا بَيِّن بَيْنَ السُلطة الدينيَّة والسياسيَّة فيه، لمجاراة المصالح بينهما، وُمضاعفة جذوة الاستبداد والقهر والتجهيل للمُجتمع بأكمله، حتَّى يكون استبدادًا مُحكَم الطريقة من شَتَّى النواحي، وبذلك يكون التناقض بين الإنكار النظري والإقرار الفعلي للمبدأ الكهنوتي في الذهنيَّة الإسلاميَّة، والواقع العربي.
لا تنوير ولا عقل
تقوم فلسفة ابن رُشد أيضًا على تكفير المذاهب والتأويلات الأخرى لغيره من المذاهب والفِرق التي تُخالِف مفهومه هو عن التأويل، وعلى تمييز الناس بين عوام وخواص، كما رأينا، وهذا هو الوجه الآخر لابن رُشد في السياق العربي لا الأوروبي، والذي أصبح أيقونةً للفلسفة والعقل والتنوير عندنا, وقليلٌ من النظر الجاد لابن رُشد سنعرف أنه لا تنوير ولا عقل ولا فلسفة في كلامه بتاتًا، على عكس ما هو معروف عنه في بعض القراءات العربيَّة الحديثة له، موصوفًا بأنَّهُ سيِّد الاستيعاب العقلي لكل الفلسفات والآراء والأفكار.
طه حسين أيقونة التنوير الحقيقيَّة
أيّها الغِرُّ، إنْ خُصِصْتَ بعقَلٍ *** فاتّبعْهُ، فكلُّ عَقلٍ نَبيّ — أبو العلاء المعري
جميعنا يعرف نقاط التشابه والقواسم المُشتركة بين شخصيتي طه حسين وأبي العلاء، كلاهما جرع من نفس الكأس وذاق المُرَّ والحنظل، كلاهما اشترك في نفس الألم وتلاقيا فيه، بالرغم من اختلاف زمان ومكان كل شخصٍ فيهما عن الآخر، وكلاهما رفض أن يعيش في سلام، وأن يميل مع أهواء المُجتمع، وأن يضع رأسه بين الرؤوس وينادي عليها بالقطع، كما يقول المثل الشعبي، وليس من قبيل المصادفة أن تُلازِم صفة الشكّ والتأرجح الفِكري كلًا مِن شاعر الفلاسفة، وعميد الأدب العربي، فبهذه الصفة بالذات تميَّزا عن الآخرين في مجتمعهما، الرافض لكل جديد، والمُتشدِّد لكل موروث.
ولكن ماذا فعل طه حسين حقًا ليكون أيقونة التنوير الحقيقيَّة؟ هذا الرجُل الذي يستحقُ مِنَّا كل التقدير وجُلَّ الاحترام!، طه حسين الذي أتى لنا برسالة التنوير الخالِصة ونبراس التقدُّم والعقل والحضارة، ما فعله الرجل لا نستطيع إلّا أن نصِفه بأنه ثورة فكريًَة شامِلة على كل الموروثات والثوابت والتابوهات، شقَّ الرجل طُرقًا في العقل العربي قلَّما جرؤ أي مُفكِّر أو مُثقف أن يغامِر ويشقَّها أو يسلكها، وأشرف على مساحاتٍ في الوعي العربي ظلَّت من المُسلَّمات أو المسكوت عنها تحت هيمنة السلطتين الدينيَّة والسياسيَّة، وكشف عن كل ما ظلَّ ستاره مسدولًا بينه وبين النقد والشكّ في مجتمعاتنا العربيَّة، وحارب الدوغمائيَّة بكل ما أوتي من إرادة، من خلال تبنِّيه الشكَّ المنهجي Methodic doubt الذي استعمله ديكارت في إثبات وجوده باعتباره الأنا الشاكَّة المُفكِّرة والناقصة، وإثبات وجود كائن كامل هو الله، ومن ثُم إثبات وجود العالم.
حاول طه حسين إدخال هذا المنهج الشكِّي في منظومة الفِكر العربي، بهدف تطبيقه على واقعنا وتراثنا الفِكري، وإعادة النظر في كل ما هو مألوفٌ ومُتعارفٌ عليه بيننا مِن تصوّراتٍ ومفاهيمٍ وقيمٍ وأخلاقٍ ومعتقداتٍ وتاريخٍ وتراثٍ وكل شيء، لمعرفة الحقيقة التاريخيَّة، والاجتماعيَّة، والسياسيَّة، والثقافيَّة، التي لا يخالطها شيء. أراد طه حسين أن يعتمِد على العقل وحده في بناء معرفة جديدة ومُستقبل جديد، ولكنَّه دفع الثمن غاليًا في حياته، وأظُنَّ أن جميعنا يعرف المناوشات والخلافات التي كانت قائمة بينه وبين الأزهر ومع رئيس الوزراء إسماعيل صدقي و(الهوجة) التي حدثت في عهده، - بعد صدور كتاب "في الشعر الجاهلي" لـ طه حسين بعد أن استعان فيه بهذا المنهج الديكارتي -، والتي انتهت بطرد طه حسين من الجامعة وتكفير الأزهر له، وحرمانه من أن يشغَل أي وظيفة حكوميَّة طيلة حياته.
« الترتيب الواضح للأفكار من أهم الحقائق التي شدَّد عليها ديكارت. وقد لا يكون للفلسفة، من دور تلعبه، إلَّا أن تُعيد النظر في المفاهيم الراهنة، لترتيبها ثانيةً بطريقة واضِحة، أي بأُسلوب منطقي.» - كمال الحاج.
ولمّا كان مفهوم العقل عند ديكارت - فيلسوف العقلانيَّة Rationalism وأبو الفلسفة الحديثة - لا يتشابه مع مفهوم العقل عند ابن رُشد، هذا العقل الجاد في البحث، وذاك المُهترئ والبالي، كان من الطبيعي أن يثور الأزهر ورجال الدين على طه حسين المُتمسِّك بهذا المنهج العقلاني الصادِق في البحث، أمَّا من يتمسَّكون بمنهج ابن رُشد المُتهاوِن والمُتخاذِل فهؤلاء لا يشكِّلون خطرًا حقيقيًا لهم وعلى سُلطتهم الدينيَّة، بل على العكس يعزِّزها وفقًا للمبدأ التراتُبي الذي ذكرناه في الجزء الأول من المقال، فَشتَّان ما بين مفهوم العقل عند ابن رُشد وبينه عند ديكارت، ذلك لأن من خصائص المنهج الديكارتي كما أوضحنا هو عدم القبول بالأفكار الموروثة على شاكلتها دون نقدٍ أو إعادة نظر، وعدم انضواء العقل تحت أي سُلطةٍ خارجيَّة، على عكس ابن رُشد في قوله بهذا الانضواء وإلزاميته، مما يجعل ديكارت ومن يتمسَّك به يُشكِّل خطرًا بالنسبة لرجال الدين على مرّ العصور وعلى سُلطتهم ومركزهم داخل المُجتمع.
بالعقل وحده نستطيع أن نصل إلى الله، دون حاجةً لنا إليكم يا رجال الدين ولا لوساطتكم. هذه هي الرسالة الحقيقيَّة التي جاء بها ديكارت، والتي أثبتها لهم بتجربته العقليَّة الخاصَّة، الأمر الذي محَقَ سطوة النزعة السكولائيَّة (التلقينيَّة) عند الفلاسفة المدرسيين في العصور الوسطي المسيحيَّة، وعزّزَ الفِكر العقلاني المستنير، ولكن هيهات أن ندرك نحنُ قيمة العقل.
« أرى أن جميع من أنعم الله عليهم بنعمة العقل يجب أن يستعملوه قبل كل شيء في محاولة معرفة الله ومعرفة أنفسهم، وهذا هو الأمر الذي اتفقت عليه جمهرة الناظرين، والذي وفقني الله إلى أن أبلغ فيه ما يرضيني تمام الرضا.» - رينيه ديكارت.
اعتراف لا بُدَّ منه.
وللحق أقول أن ما نال إعجابي في كتاب ابن رُشد هو آخر فصل منه، والمُعنوَن بـ "ضميمة العِلم الإلهي"؛ ففيه يتكلَّم ابن رُشد عن العالم بين القِدم والحدوث، واختلافه هو وابن سينا والفارابي مع الغزالي في هذه المسألة. وينبغى أن نعرف أن استمساك ابن رُشد وغيره بهذه الفِكرة ليست من قبيل الاستعلاء أو الجحود والإنكار، لأن الغايَّة من ذلك كانت تنزيه الذات الإلهيَّة في إرادتها ومشيئتها، والمسألة في حد ذاتها كانت مُبهِرة بالنسبة لي، وتُعتبَر هي الإسهام الميتافيزيقي الوحيد الذي قرأته لابن رُشد وأعجبني؛ فبالرغم من استمداد ابن رُشد فِكرة اللامتناهِ في القِدم من أرسطو، إلا أن ما فعله ابن رُشد هو ربط أزليّة أو قِدَم العالَم بالعِلم الإلهي القديم وجَعَل هذه مرهونة بتلك، إذ لو كان الكون حادثًا - من وجهة نظره - فإن ذلك يستلزم حدوث عِلمًا زائدًا في العِلم القديم - يقصد علم الله -، وبذلك يصبح العلم المُحدَث عِلَّةً لعلم الله لا معلولًا له، وهذا عند ابن رُشد لا يصح، لأن الله هو العليم بكل شيء أزلًا في المعرفة وأبدًا في الحدوث، يقول: «والعِلِم القَدِيم هُوَ عِلَّةٌ وَسَبَبٌ لِلمَوجُودِ» وليس العكس، وفي وجهة نظره أن ذلك خيرُ التنزيه عن الله وعلمه الأزلي ومشيئته وإرادته، فكان الفرق الوحيد بين الله والعالَم عنده هو في الرُتبة فقط، أمّا في الزمن فالله والعالَم أزليان.
"فَلَو كَانَ، إِذَا وُجِدَ المَوجُودُ بَعدَ أَن لَم يُوجَدْ، حَدَثَ فِي العِلمِ القَدِيمِ عِلمٌ زَائِدٌ كَمَا يَحدُثُ ذَلِكَ فِي العِلمِ المُحدَثْ، لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ العِلمِ القَدِيمُ مَعلُولاً لِلمَوجُودِ لاَ عِلَّةً لَهُ."
أتمنَّى لو أن يقرأ الناس هذه الفِكرة الفلسفيَّة بقليلٍ من الصبر والحِكمة وبدون أي فروضٍ مُسبقة وتسرُّعٍ يحجب الحقيقة، وأن يزهدوا ولو قليلًا في إطلاق أحكام الكُفر والزندقة والهرطقة، وأن ننزل قليلًا عن الفِكر الاستعلائي المتجاهِل للآخر، والمُعتقِد في مُطلق كل شيء، لأن اللحاق بركب الحضارة فعلًا يأتي عن طريق التسامح والعفو، وقبول الآخر، والاستيعاب لكل الفروق والاختلافات في الفكر، في الثقافة، في الفن، في العقيدة، في الرأي، وفي الحياة.