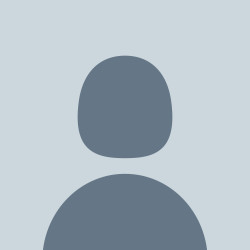في مجتمع يمارس الكبت على جميع الأصعدة لا بدَّ وأن يُعابَ فيه من يمارسُ الحُبَّ علناً ، فتجدُ رهبةً في نفسكَ من الاعتراف به أو حتى في الحديث عنه، في حين أن الكراهية تطفو على السطح ويبقى الحبُّ كلمةً منسيةً في القاع نستخدمها استخداماً عرضياً لا لذاتها ولكن للأهداف التي تتحقق من خلالها.
يبرر الناس سلوكاتهم المليئة بالكراهية بأن الهدف منها مقبول بل وسامٍ، فالأب الذي يبرحُ ولدهُ الصغيرَ ضرباً ثم بعد أن تخرَّ قواه وينال الزمان منه يدّعي أمام ولده بأنه كان يفعل ذلك حرصاً عليه وحباً له، والمقاتل الذي ينحر رقبةَ أخيه الإنسان يدّعي كذلك حبه لله، فيغيب عن أذهانهم أنه إذا ما كانت الغاية حباً فلا يمكن أن تختلط الوسيلة بالكراهية.
الحقيقة أن هذا العنف الذي نعاني منه اليوم على اختلافِ أنواعهِ ومستوياته ما هو إلا ثمرة سنين عجاف من غياب لغة الحبّ وتقديم لغةِ الكراهية عليها وجَعْلِها مكرّمةً في مجالسنا، وفوق منابرنا، وبمدارسنا، وبين أصحابنا، وخلال الشاشات التلفزيونية، والمحطات الإذاعية.
يولد الإنسان صفحةً بيضاء ثم ما أن يُتمَّ الخامسة من عمره حتى تمتلئ صفحته بأشياء لم يخترها، لا اسمه ولا أهله ولا بلده ولا قبيلته ولا ديانته، وكل هذا طبيعيٌّ إلى أن يقنعه محيطه بإضفاء الأفضلية لنفسه عبر تلك الأشياء، فيبدأ بتعلم اللغة الملعونة الآنف ذكرها (لغة الكراهية)، ويبدأ ببغض الآخرين في مرحلة اللاوعي حتى يصبح مشحوناً تماما بالكره، ويبدأ بالتعرف على لغة الحب لأول مرة مع ظهور حاجاته النفسية أو الغريزية أو كليهما، فلا يعرف معنىً للحبِّ إلا إذا اقترن بحاجة!
تعزى الكراهية كذلك لأسباب أشدّ خطراً، وأكبر تأثيراً لأنها مدروسةٌ من قبل من صنعوها وكانت في وقتٍ سابقٍ قد خدمت مصالحهم، فماتوا ولم تمت أفكارهم بل أصبحت شرعةً ومنهاجاً للإنسان البسيط الذي يَعتَبِرُ رجلَ الدينِ مرجعه الوثيق لكل صغيرةٍ وكبيرةٍ يواجهها.
الخوض في مثل تلك الأسباب يُعَدُّ محظوراً وقد يُعرِّضُ الخائض فيها للمساءلة المجتمعية وأحياناً القانونية، لأنه من خلالها تقوم الدول وتبرر نفوذها وتُشَنُّ الحروب وتراق الدماء، فأكبر خديعة للإنسان البسيط هي أن الدين يقوم على بغض الآخر والتمييز بين الناس على اختلاف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم ومللهم، وأن الأديان جاءت لتمييزِ شعبٍ على آخر أو ملة على أخرى، وإكساب الأهلية لمنتسبي تلك الديانة أو الملة بالحكم المطلق للبلاد والعباد.
ومع تعدد الديانات وما نشأ عنها من الملل والمناهج والطرق وجب تعديل بوصلتنا نحو الإنسانية وحدها، ولتُهمَل كلّ تعاليمٍ أياً كان مصدرها إذا ما كانت تتعارض مع إنسانيتنا.
وقد يرى البعض هذا تطاولاً على الدين، ولكن عندما نعي أن مهمة الدين الرئيسية هي زرع القيم الإنسانية وتوطيد روابط المحبة بين الناس سنعرف أن الإنسانية هي اللقب الغير معلن للديانات، أو الوجه الآخر لها.
إن الحرب هي الحرب، سواء أسميناها فتوحات إسلامية أم حملات صليبية، ستبقى الحرب ما يخدمُ كبار القوم ويدفع ثمنها صغاره، بيدَ أن الكهنوت الملتف حول السلطة داعماً لها ومستفيداً منها سيتولى أمر البسطاء في إقناعهم بشرعية الحرب وتحريضهم على ما من شأنه تحقيق المطامع التوسعية لكبارهم، فقد يقنعك الكاهن مثلاً بأن الغاية من خلقنا في هذا التنوع والاختلاف هو الاقتتال حتى لو كان لكتابك المقدس رأي مخالف: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

أرى أن إدراكنا لهذا سيفتح آفاقاً جديدة في تعلم لغة الحب، وستكون نقطة البداية للتمييز بين ما يريده الله وما يريده من يتحدثون باسمه.